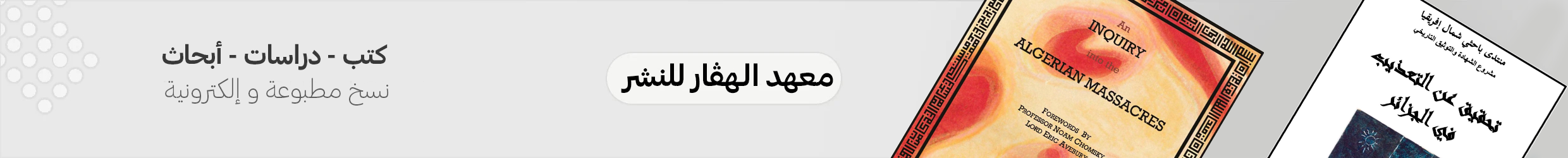لا بد أن الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي يعرف لدى الكثيرين باسم أبيه مباشرة ويدعى “عبد الكريم الخطابي” يبقى من الرجال المأثورين في التاريخ الذين أثروا في تاريخ بلادهم، المغرب، ولكنه علاوة على ذلك كان الرجل المغاربي بامتياز خاصة بعد عودته من المنفى؛ إلا أن نظرته هذه لم تجد تفاعلا جديا، كما لعب التنافس الشخصي وحب الزعامة دورا في فشل بعض المبادرات التي أطلقها. يجدر أن نلفت النظر هنا أيضا إلى شخصية الأمير القوية، وخلافاته أو علاقاته الباردة مع علال الفاسي تبرز نوعيتها.
بغض النظر عن تأتي السماح للأمير بالعودة من منفاه عن رغبة فرنسية في الضغط على ملك المغرب سيدي محمد بن يوسف وتخويفه أو مناورة من المخابرات الفرنسية في ظل الحكم الاشتراكي لمواجهة نظام الجنرال فرانكو في المغرب وإثارة حرب ريف جديدة، وعن كون نزوله ببور سعيد كان مخططا له أو عارضا بتدخل القيادات المغاربية، فذلك يتعلق بسيرته الشخصية، ما سنركز على تحليله هو التوجه المغاربي للأمير وعلاقاته مع الوطنيين في المغرب الكبير.
نجد في النداء الذي وجهه الأمير الخطابي للشعوب المغاربية غداة تأسيس لجنة تحرير المغرب الكبير التوجهات التي كان ينادي بها وكذا البعد الإسلامي الجوهري في هذا التحرك، كما أن سعيه لإطلاق ثورة بشكل متزامن في البلدان المغاربية الثلاث عن طريق جيش تحرير المغرب العربي يشكل دليلا ملموسا على الإرادة الفعلية لتحقيق ميثاق هذه اللجنة الذي نص على أن استقلال أي بلد من البلدان الثلاث لا ينه دور اللجنة في العمل على تحقيق استقلال البلدين الآخرين وكذا دور البلد المستقل في مواصلة دعم النضال. وقد بدأت أولى الخطوات الفعلية لهذا النشاط عن طريق إرسال البعثة العسكرية المغاربية الأولى إلى بغداد في إطار تكوين قيادات جيش تحرير المغرب العربي التي تكونت من : 1- محمد إبراهيم القاضي، جزائري من باتنة (سلاح الهندسة)، 2- يوسف العبيدي، تونسي (سلاح المدرعات)، 3- الهادي عمر، تونسي (سلاح الإشارة)، 4- أحمد عبد السلام الريفي (حدو عبد السلام أقشيش)، سلاح المشاة، 5- عبد الحميد الوجدي، مغربي (سلاح المشاة)، 6- الهاشمي عبد السلام الطود، مغربي (سلاح المدرعات)، 7- محمد حمادي العزيز [مؤلف كتاب جيوش تحرير المغرب العربي]، مغربي (سلاح المدفعية). عادت هذه البعثة في 1951.
عاد الأمير إذن ليلعب دوره الفعلي في التحرير المغاربي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، بعد عشرين سنة من النفي بجزيرة لاريونيون تلت انتهاء مقاومته البطولية في 1926، ثم لجوئه إلى مصر. نشير هنا إلى أن أمازيغيته كان لها دور في المواقف التي اتخذها إزاءه كثير من القيادات، سواء من دافعت عنه أو من دخلت في صدامات معه.
إن قصة جيش تحرير المغرب العربي، ولجنة التحرير المغاربية التي ترأسها الأمير في القاهرة وما تلاها من تطورات فيها من العبر ما فيها، لأن تملص بعض القادة التونسيين والمغاربة مما وُقع عليه حول الاستقلال الشامل للبلدان الثلاث، أثر على العلاقات بين القيادات، فقد نصت بنود ميثاق لجنة تحرير المغرب العربي :
– الاستقلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة أقطاره الثلاث :تونس والجزائر ومراكش.
– لا مفاوضة مع المستعمر في الجزئيات ضمن النظام الحاضر.
– لا مفاوضة إلا بعد إعلان الاستقلال.
– حصول قطر من الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لا تسقط عن اللجنة واجبها في مواصلة الكفاح لتحرير البقية.
وقد صادق على هذا الميثاق ممثلو الأحزاب المغاربية المتواجدين بالقاهرة كالحبيب بورقيبة من تونس والشاذلي المكي من الجزائر وعلال الفاسي وعبد الخالق الطريس من المغرب. إلا أن العلاقات داخل هذه اللجنة، التي تأسست في 1948، لطالما بقيت متشنجة لأسباب تتعلق بالاختلاف حول الرؤى وسبل النضال ما أدى إلى عزل الأمير. يقول محمد الحمادي العزيز في مؤلفه “جيوش تحرير المغرب العربي، هكذا كانت القصة من البداية إلى النهاية” :
“بيد أن جوهر المسألة لا يكمن في نشاط اللجنة أو عدمه، وإنما في سياسة التجاهل التي انتهجها أعضاء المكتب تجاه محاولات عبد الكريم لإعداد آليات الكفاح المسلح، والعمل على ترجمتها على الواقع المغاربي. فقد كانوا يجارونه … وفي الوقت ذاته يواصل كل واحد منهم نشاطه من زاوية حزبية مفتوحة على بلده فقط. وقد رسم عبد الكريم غلاب [وهو أحد الناشطين السياسيين في المكتب] صورة موحية عن فكرة التحرير كما يتصورها عبد الكريم الخطابي، وبعدها عن تصور الأحزاب السياسية، حينما قال: ” إن الخطابي كان رجلا عسكريا بالممارسة، يؤمن بأن الاستعمار لا يمكن القضاء عليه إلا عن طريق الحرب. وهذه فكرة مخلصة، ولكن الواقع والظروف تغيرت، لأن نضاله كان في أوائل العشرينات، وكنا نحن في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات. فمن الصعب جدا تحقيق هذه الفكرة”.
ومع ذلك، فقد استمر تكوين العسكريين، وفي هذا الإطار تأتى تكوين هواري بومدين، أو محمد بوخروبة اسمه الحقيقي، وغيره، لأن العمل المسلح كان معروفا بأنه سيأتي ولكن الطرف الذي سيطلقه لم يكن أكيدا، ولهذا كان المدربون يخبرون المغاربيين من المتربصين أنهم مسؤولون عن تدريبهم فقط وأن ليس لديهم مشروع عمل مسلح في شمال إفريقيا لكي لا يلوموهم بعد انتهاء فترة التدريب؛ نشير هنا إلى أن اندلاع الثورة في الجزائر بقيادة جبهة التحرير الوطني أتى ليستوعب الإطارات العسكرية الجزائرية المكونة في مصر خاصة في ظل تضاؤل فرص نجاح جيش تحرير المغرب الكبير.
كان السبب الرئيسي لعدم تجسيد فكرة جيش تحرير المغرب العربي بشكل فعلي يتمثل في سعي الجناح البورقيبي، الذي بدأ انتصاره يلوح في الأفق، في تونس للالتزام القطري واستغلال إنجاز الاستقلال الداخلي في مواجهة اليوسفيين وكذا مساعي قيادات من حزب الاستقلال لا تحبذ الكفاح المسلح لأنه يقلب موازين القوى ويؤدي إلى بروز قيادات وتوجهات جديدة. ويمكن أن نجزم بأن عدم التوحد هذا وعدم تفعيل جيش التحرير المغاربي قد سبب مشاكل بالبلدان المستقلة حديثا، يمكن أن نعدد منها :
– استقلال المغرب مع بقاء قوة أجنبية، لأن المقاومة المسلحة لم تعرف تطورا نتيجة رغبة بعض القادة السياسيين في مراكش [حزب الاستقلال] في إضعافها أو توقفها بشكل تام، وكذا النظام الملكي، من أجل مصالح ضيقة، وهكذا نجد خاصة قضية سبتة و مليلية.
– مشاكل تونس، واغتيال بن يوسف، التي بقيت آثارها تتبع الحبيب بورقيبة طوال فترة حكمه، وأدت في الأخير إلى تقليص هامش الحريات إلى أقل درجة ممكنة، لأنها كانت باب إحراج، وتقلصت عبرها كافة الحريات السياسية.
– تأخر استقلال الجزائر إلى غاية 1962، بسبب تفرغ القوات الفرنسية لجوهرتها : المستعمرة الجزائرية وتركيز جهودها للحفاظ عليها.
في الختام ينبغي لفت النظر إلى أن محمد بن عبد الكريم الخطابي، المقاوم المغاربي لم نيل ما يستحقه من الاهتمام في تونس والجزائر، وإن كان الأمر مماثلا بالمغرب الأقصى نظرا لاعتبارات داخلية لا ينبغي التركيز عليها تفاديا للحساسيات، وعلى معدي المناهج في كل من تونس والجزائر الاهتمام بهذه النقطة لأن الأمر يتعلق بجزء من التاريخ المغاربي المشترك ولا يخص بلدا معينا على حدة.
خليل وداينية
5 جويلية 2013